|
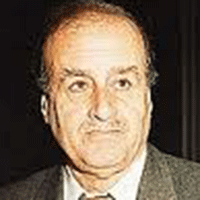
عندما كان المترجمون أدباء كباراً
أ. جهاد فاضل
من يراقب الحياة الثقافية العربية المعاصرة يجد أن الترجمة في تراجع مستمر. فمن حيث العدد لا شك أن الكتب المنقولة إلى العربية كانت قبل خمسين عاماً أكثر من الكتب التي تنقل اليوم. كما كانت الترجمة أجود، لأن قسماً كبيراً مما كان ينقل كان يضطلع به أدباء وكتّاب عرب كبار.
ويبدو أن وراء تراجع حركة الترجمة عدة أسباب، منها أن الذين يتقنون اللغات الأجنبية، واللغة العربية أيضاً، لم يعودوا بنفس الوفرة التي كانوا عليها في الماضي.
ومن هذه الأسباب أيضا نظرة المجتمع للترجمة، فالترجمة في منطق هذه النظرة، تقف دون التأليف درجة، فهي لا تدخل في إطار الإبداع، ولا تستحق بالتالي تقييماً يعلي من مرتبتها بين العلوم، يضاف إلى كل ذلك قلة عائد الترجمة، وقد تضافرت كل هذه الأسباب لتؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي ضعف الإقبال عليها.
مع أن العالم العربي يتوافر في الوقت الراهن على مؤسسات منظمة للترجمة تصدر كتباً منقولة إلى العربية بين وقت وآخر، وبعضها ينشط في هذا المجال مثل المشروع القومي للترجمة في مصر، والمنظمة العربية للترجمة في لبنان، إلا أن كل ذلك لا يغير أو يبدل في الصورة العامة، فالترجمة الى العربية مجرد فرع بسيط في حياتنا الثقافية، والمترجم لا يحظى بالاهتمام اللازم الذي يحظى به في البلدان الأجنبية، ولا ينفي أحد أن هذا المترجم قد يكون مسؤولاً عما لحق بمهنته من بوار وسوء فهم والتباس في الذهن العام، لأن الكثير مما ينقله الى العربية لا ينقله بأمانة، وصدقيته في أحيان كثيرة موضع شك.
فلنترجم
ولم يكن هذا هو حال الترجمة إلى اللغة العربية منذ أطلق ميخائيل نعيمة في كتابه «الغربال»، وقبل حوالي 100 سنة من اليوم، صرخته الشهيرة: «فلنترجم» استناداً إلى فقرنا الثقافي المدقع وحاجتنا إلى فتح أبواب التواصل مع اللغات الحية والحضارة الحديثة.
ومنذ الثلاثينات من القرن الماضي وصولاً إلى وقت قريب نسبياً، كثيراً ما كان المترجم واحداً من كبار الأدباء، فها هو طه حسين يترجم «روح التربية» لغوستاف لوبون، و«نظام الاثينين» لأرسطو، ومجموعة من مسرحيات سوفوكليس، و«زاديغ» لفولتير، و«أديب وسبوس» لأندريه جيد. وترجم أحمد لطفي السيد «السياسة» لأرسطو. ونقل قدري حافظ طوقان عددا من أمهات الكتب الأجنبية، منها كتاب «الأبطال» لكارليل. ونقل سامي الاروبي تراث دستوفيسكي بكامله تقريباً، وترجم خليل مطران عدداً من مسرحيات شكسبير. وترجم جبرا ابراهيم جبرا عددا وافراً من الكتب الاجنبية لصامويل بيكيت ولافونتين وأوسكار وايلا وفولكنر. وترجم غسان كنفاني لنينسي وبليانر، وإدوار الخراط اكثر من عشرة كتب، منها: «الحرب والسلم» لتولستوي، ومسرحية «أنتيغون» و«ميديا» لجان أنوي، و«والسرير المائدة» لبول ايلوار، و«حوريات البحر» لمجموعة من القصاصين الأميركيين.
من العربية وإليها
وكذلك ترجم أدمينس ست مسرحيات لجورج شحادة ومسرحيتين لراسين، كما ترجم عدة دواوين لسان جون برس، جمعت في جزأين، ومجموعة مختارة من قصائد ايفا بونفوا، كما ترجم إلى الفرنسية «لزوميات» أبي العلاء المعري، وكتاب «المواكب» لجبران خليل جبران. وترجم ممدوح عدوان «تقرير ال غريكو» لكازاتزاكي، و«الرحلة الى الشرق» لهيرمان هيسا، و«النار في المرة القادمة» لجيمس بالدوين، و«الألياذة» لهوميروس.
وترجم حافظ إبراهيم رواية «البؤساء» لفيكتور هيغو، وقد يكون فرح أنطون وأديب إسحق من أدقّ المترجمين في القرن التاسع عشر الذي راج فيه التصرف في الترجمات. ومن بين الذين كانوا يتعاملون مع النص بهذه الطريقة طانيوس عبده ومصطفى لطفي المنفلوطي ولبيبة هاشم. أما الذين سعوا إلى تقديم ترجمات تضاهي الأصل، فيجب ذكر سليمان البستاني الذي ترجم «الإلياذة» شعراً، وحاول في ترجمته أن يقدّم للقارئ العربي نصاً جميلاً لا تشتم فيه رائحة الترجمة، وترجم قريب له هو وديع البستاني «المهابراتا» الهندية، وهو أقدس الكتب عند الهنود.
دقة وأناقة
وازداد الميل إلى الدقة في الترجمة على يد الكتاب الكبار اللاحقين مثل طه حسين وسامي الدروبي وجبرا إبراهيم جبرا وإدوار الخراط، وراح بعض المرجمين يعدون أنفسهم سنوات طويلة للعمل الذي يقدمون على ترجمته وصاروا يهجسون به ليل نهار، فأتت ترجمتهم متأنية وأمينة وأنيقة.
بقي حسن عثمان في ترجمة «الكوميديا الإلهية» لدانتي زهاء 35 سنة تزوّد فيها بمعلومات فنية وأدبية واجتماعية عن عصر دانتي وعن الشاعر نفسه، فنقل الأجواء التي عاشها دانتي إلى القرن العشرين، وذكر جبرا إبراهيم جبرا أنه بدأ يترجم «هاملت» لشكسبير عام 1959، ولكنه لم يجرؤ على نشرها إلا بعد عشرين سنة قضاها في الكتابة والبحث عن عوالم هذا الشاعر العظيم. ويضيف: وفي رأسي كلما جابهتُ النص الإنكليزي زوبعة من الصور أحاول التحكم بها في لغتي كما تحكم الشاعر الكبير بها في لغته، فأخشى عليه، وعلى لغتي، وعلى ما أترجم، ولكن النشوة في مجابهة النص كانت هائلة. عندما فرغت من ترجمة هاملت انتابني شعور بأن الجهد النفسي الذي عايشته، على متعته الهائلة، قد يصعب عليّ أن أعانيه مجدداً! ولكنه أقدم على ترجمة كبرى المآسي الشكسبيرية. وقد ذكر أن ترجمة شكسبير كانت بالنسبة له فعل حب، أو فعل إنقاذ: «وأنا من دأبي ألاّ أُترجم، إذا ترجمت، إلا عن حب. وكل ما أترجمه لا أتصدى له، إلا إذا شعرت أنه رئة أخرى لي أتنفس بها، وأنني في عالمه كأنني في عالم من صوري وهواجسي».
كتاب واحد كل عام
وأذكر أن جبرا إبراهيم جبرا قال لي مرة إن مشكلة الترجمة إلى العربية يمكن حلّها إذا فرضت الجامعات العربية على أساتذتها ترجمة كتاب واحد في السنة، كلٌّ في اختصاصه، قال لي: «تصوّر أثر ذلك خلال سنوات عدة، يُفترض في الأستاذ الجامعي أن يترجم بأمانة وإخلاص. وإذا تصورنا أن هذا الاقتراح سيُفرض على أساتذة الجامعات، فلاشك أن هناك نهضة كبيرة في الترجمة وفي الثقافة العربية ستحصل.
وقد قرأتُ مرة، في باب أمانة المترجمين المحترفين، أن سامي الدروبي الذي نقل دستويفسكي إلى العربية نهض مرة بعد منتصف الليل من فراشة إلى مكتبه ليستبدل عبارة بأخرى، كان ذلك هو في أشد حالات مرضه الذي انتهى بوفاته.
زمن المسؤولية
كان ذلك في زمن الشعور بالمسؤولية، وفي زمن المشاريع الثقافية والنهضوية كانت هناك نهضة عارمة للثقافة، وكان هناك اهتمام كبير بالترجمة لنقل ما عند الشعوب الأخرى من آداب وعلوم على شتى الصُعد. وكان الهدف هو تحريك سواكن الأمة وتراثها وحضارتها، وضخ مزيد من الحيوية والنماء في أجيالها الصاعدة. كانت الترجة أداة نهضة ووسيلة تقدم أكثر مما كانت مهنة أو حرفة، بدليل أن كبار القوم في دولة الأدب زاولوها. فلما تراجعت الأمة وانتكست مشاريعها النهضوية، تراجعت الترجمة بدورها لتتحول إلى «توليفة»، في الأعم الأغلب، يحبكها المترجم أو الترجمان، مزاجه فيما إذا لم يتمثل النص الأجنبي تمثلاً صحيحاً إلى أن وصلنا إلى ما يمكن تسميته ببؤس الترجمة!
القبس
|
|
|
|