|
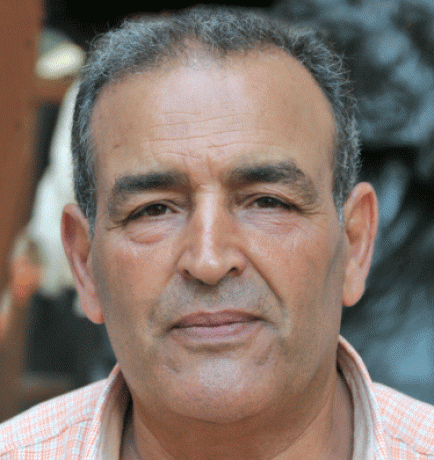
فينوس في منشور مزوّر: من أجل ساعة أسبوعيّة للضاد
أ. منصف الوهايبي
أثارت السيّدة نجاة ولّود بلقاسم، منذ تعيينها على رأس وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا؛ ردود فعل مشينة في شتّى المواقع الاجتماعيّة؛ كلّها كراهيّة وعنصريّة بغيضة. ولا سبب لذلك ـ على ما يبدو ـ سوى كونها تتحدّر من أصول عربيّة مغربيّة، إذ لم يتعرّض أيّ من وزراء التربية في فرنسا؛ إلى مثل هذه الحملة. ومع ذلك فإنّ في هذا بعض العزاء، بل ربّما كان «المنشور المزوّر» المنسوب إلى السيّدة نجاة، ضربة صائبة. فقد تناقلت المواقع الاجتماعيّة هذا «المنشور» الذي ينصح «بحيويّة» أو «حُمَيّا» رؤساء بلديّات فرنسا «بتخصيص ساعة أسبوعيّة،لاكتشاف اللغة العربيّة». فما الذي يجعل مثل هذا «الاقتراح» الذي لم يصدرعن الوزيرة أصلا، يثير هذه الموجة العاتية من السخرية؟ وكيف يجيز هؤلاء لأنفسهم، أن يتّخذوا من لغة «يتكلّمها» أكثر من 300 مليون نسمة، مُلْحة مسلّية، وأن يتجاهلوا أنّ العربيّة هي إحدى اللغات الستّ الرسميّة، في الأمم المتحدة؟ بل كيف يوقعون «الدلْسَة» بين العربيّة و»الأصوليّة» الإسلاميّة سواء أكانت «إخوانيّة» أو «جهاديّة»، في حين أنّ غالبيّة المسلمين مثل الأتراك والأندنوسيّين والصينيّين والباكستانيّين… لا يتكلّمون العربيّة، وأن يجعلوا، بضربة ساحر وبراعة بهــلوان، هذه تلك، في بلد يعـــيش فيه خمسة ملايين من «الناطقين بالضاد» الأمر الذي يجعل العربيّة ثاني لغة متكلّم بها في فرنسا؟
إنّ الحضور العربي، في فرنسا قديم جدّا، وهو يعود إلى ثلاثة عشر قرنا أو أكثر، كما جاء في المصنّف الجماعي «فرنسا العربيّة الشرقيّة» الذي قدّم له بنجمان ستورا (منشورات لاديكوفارت 2013). وكان الوزير جان بيير شوفانمان، الذي شغل منصب السيّدة نجاة، قد دعا عام 1985، المستعرب الفذّ جاك بيرك، إلى التفكير في تدريس العربيّة بفرنسا. وقد كتب هذا يقول «إنّ الثقافة الفرنسيّة، ينبغي ـ دون أن تنقطع عن كونها ثقافتنا الوطنيّة ـ أن تتطعّم وتغتني بإسهام الثقافة العربيّة الإسلاميّة. والثفافة الفرنسيّة تمتلك تقليدا انسانيّا قديما، من شأنه أن يسمح بفتح مثل هذه الآفاق». ويتناسى البعض أن العربيّة قد نُصّ عليها «لغة فرنسا» عام 1999 في المعاهدة الأوروبيّة للغات المحليّة والأقليّة، وأنّها أقدم من الإسلام، وأنّ مسيحيّي الشرق يتكلّمون العربيّة، ويصلّون بها، وبها يقيمون طقوسهم وسائر شعائرهم. بل إنّ فرنسا التي كانت امبراطوريّتها تشمل سوريا والمغرب الكبير؛ هي التي بعثت «كرسي اللغة العربيّة» في الكوليج دو فرانس منذ 1530، وكان كولبار وزير لويس الرابع عشر، قد أنشأ مدرسة اللغات، لتسهيل المبادلات التجاريّة والعلاقات الديبلوماسيّة بين العالم العربي والأمبراطوريّة العثمانيّة. بل إنّ من خيرة أساتذتنا في الجامعة التونسيّة، الحاصلين على شهادة التبريز في العربيّة من فرنسا. وهي الشهادة التي أُقِرّت منذ عام 1906. حقّا كان ينبغي على هؤلاء المروجين لـ»المنشور المزوّر» أن يطلعوا على ما كتبه إدوارد سعيد مستأنسا بالمستعرب جاروسلاف ستيكوفتش الذي خصّص للعربيّة أحد أفضل الكتب عند المعاصرين؛ من أنّ العربيّة «لغة تقع ـ بشكل منقطع النظيرـ في المركز من الثقافة العربيّة. وأنّها مثل فينوس، وُلدت في صورة الجمال الكامل، واحتفظت بهذا الجمال، على تبدّل الحال في هيئة كلّ زمان ومكان»…
ومع ذلك فإنّ من أصدق الطّرق لفهم العرب أنفسهم، وصف لغتهم، والوقوف على نصوص وتفاصيل كافية تصوّرها على حقيقتها. والحقّ أنّنا لا نملك صورة وافية واضحة الوضوح كلّه، لنموّ العربيّة وتطّورها لا في القديم، ولا في القرون اللاّحقة عليهما. وأسباب هذا القصور، أكثر من أن نتتبّعها في حيّز كهذا. فهي تعزى إلى اتّساع الرّقعة المكانيّة وما أدّى إليه من اضطراب في تحديد اللّهجة الفصيحة، وأختلاف المادّة اللّغويّة وتشعّبها وتشتّتها، وانصراف النّحاة عن العامل الزّمنيّ في تطّور اللّغة. وربّما كانت لغة القرآن أهمّ هذه الأسباب. وللقرآن فضل كبير في تطوّر المباحث اللّغويّة عند العرب، ولم يحدث حدث في تاريخ العربيّة أشدّ أثرا منه. ونستطيع أن نتلمّح ذلك في سائر مصنّفات اللّغة وهي التي تدور كلّها على حفظ هذا النصّ، وحياطة اللّسان الذي تأدّى به؛ كما لو أن اللّغة قانون نافذ على الدّهر؛ فلا ينبغي لعصر يأتي إلاّ أن يكون من جنس زمن الوحي والقرن الأوّل. فلعلّ هذه القداسة المثيرة التي أسبغوها على القرآن ـ وهم الذين جرّدوه من رقّ الزّمان والمكان ـ كانت من أهمّ الأسباب التي صرفتهم عن العامل الزّمنيّ في تطوّر اللّغة؛ بل ربّما حجبت عنهم؛ ما تعكسه لغة القرآن نفسها، من مراحل متفاوته في تطوّر العربيّة اللّغويّ ومن فروق شتّى بين أداء شفهيّ وأداء كتابيّ.
كنت أقول إنّ كتاب المستشرق الألماني يوهان فك الموسوم بـ «العربيّة: دراسات في اللّغة واللهّجات والأساليب» وهو أشبه بدائرة معارف واسعة؛ قد يكون من أهمّ المصنّفات الحديثة التي لامست هذه الصّورة واستوفت جوانب غير يسيرة منها. فقد تعقّب فك تاريخ العربيّة في عصور مختلفة وأزمنة متفاوتة، ابتداء من العصر الأموي خاصّة فالعّباسي وانتهاء بعصور السّلاجقة وزحف المغول. واستطاع وهو الذي اقترن لديه الاستقراء التّاريخي بالعقل اليقظ وقوّة الوصف والتّمثيل، أن يجلو عصورا غابرة من تاريخ العربيّة، وأن يبتعث «فينوس» هذه من ماضيها الدّفين. ولكن عسى أن يكون هذا «المنشور المزوّر» المنسوب إلى السيّدة نجاة، ضربة صائبة، توقظنا من سباتنا ومن أوهامنا. وما أكثر أوهامنا عن أنفسنا، وعن لغتنا.
القدس العربي
|
|
|
|