|
|
|
|
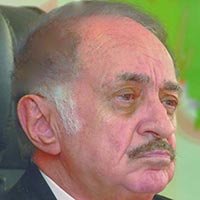
راهن اللغة العربية في أوطانها - مقارنات - 5
د. محي الدين عميمور
اللغة الوطنية الواحدة والمُوحِّدة هي عصارة الثقافة الوطنية في البلد المعني وعنوانها، بل إنها اختزال لصفة الوطنية، وهي صورة لوحدة الأمة أيا كانت أصولها وأعراقها، وتجسيد لهيبتها وتأكيد لعزتها وتعبير عن كرامتها، ومن هنا كنت أرفض دائما مفهوم "الازدواجية" اللغوية الذي يجعل من الفرنسية آليّا الطرف الآخر من الثنائية المُستعملة، فتخلق للّغة الوطنية "ضُرة" تقوم بدور السبية سالفة الذكر، وكنت وما زلت أفضل الحديث عن "التعددية" اللغوية، التي تكون العربية قاعدتها الرئيسية، ولن أضيع وقتا طويلا في اجترار ما سبق أن تناولته، والذي أكدته المشاكل الأخيرة في بلجيكا، وأكتفي بالقول بأن وحدة اللغة الوطنية هي ضمان وحدة الوجدان الوطني، وهو ما لا يتناقض مع الاستفادة بأي فنون شعبية أو ثقافات محلية، لا تتجاهل الرمز المُوحَّد والموحِّد للأمة، وما لا يمنع من الانفتاح الواعي على ثقافة العالم وفنونه.
والجماهير في جل بلاد العالم تلتف حول رمز واحد تجمع عليه بدون أن يعني ذلك سحق رموز أخرى، جهوية أو مزاجية، أو تجاهل رموز أخرى عالمية، وهكذا نجد "إديث بياف" في فرنسا و"أم كلثوم" في مصر و"فيروز" في لبنان و"إلفيس بريسلي" في أميريكا و"البيتلز" (وليس الخنافس) في بريطانيا، وكلها رموز تمثل مرجعية فنية لكل مواطن، لا تحول بينه وبين أن يحب "عبد الوهاب" ويعجب "بعبد الحليم" ويعشق "بيتهوفن" ويسهر مع" فردي" وينسجم مع" تشايكوفسكي" ويرقص مع "كوستاغوفيتش" ويُغني مع "آزنافور" ويطرب" لدحمان الحراشي".
وتبدو أهمية هذا المثال عندما نسجل أننا لا نجد عندنا مطربا واحد يجمع عليه كل المواطنين، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وربما كان الاستثناء الجدير بالانتباه هو بعض الأناشيد الوطنية، ربما لمجرد أنها تجسد الوحدة الوطنية.
لكن المثير للأسى هو أن بلادنا لم تعرف أغنية وطنية واحدة جديرة بهذه الصفة منذ أنشودة "عيد الكرامة" في منتصف الثمانينيات، ولعل المسؤول الأول عن هذا هو خلل وحدة الوجدان الوطني بفعل الشروخ اللغوية التي تفاقم أثرها وتأثيرها.
أما في المجال الأدبي فإننا سنجد أن روسو وفيكتور هيغو وبلزاك وديماس، الكبير والصغير، عند الناطقين بالفرنسية هم رموز للإعتزاز بالوطن مثل شيكسبير وألدوس هكسلي وإدغار ألان بو وتينسي وليامز وغيرهم عند الناطقين بالإنغليزية، كما أننا نجد كل مصري يحرص، مهما كان اتجاهه السياسي، على قراءة "الأهرام" حرص الفرنسي على قراءة "لو موند" والبريطاني على قراءة "التايمس" والأمريكي المُسيّس على قراءة "الواشنطون بوست" واللبناني الماروني على قراءة "النهار" وزميله السني على قراءة "الأنوار"، وهي هنا ثنائية تستحق التوقف عندها عندما نعرف أن "الفلامان" في بلجيكا لا يقرؤون صحيفة "لو سوار".
وفي بلد يُصدر أكثر من ستين صحيفة، بعضها لا علاقة له بالهدف الحقيقي لوجود الصحافة، لعلي أتساءل عن خريطة توزيع القراء على الصحف، وأقصد أساسا القراء الذين يشترون الصحف، وبالتالي عن نسبة مقروئية كل صحيفة وكل مجلة، وعن الكتاب الذين يتابعهم جل المواطنين ويتأثرون بما يكتبون، وأتساءل هل عندنا أمثال "غسان تويني" في لبنان و"حسنين هيكل" في مصر "وفونتين" في فرنسا "وروبرت فيسك" في بريطانيا و"سالزبيرغر" في بلاد الأمريكان وغيرهم من خلق الله في بلاد الله؟.
وربما دفعت السكين في الجرح أكثر فأكثر لأتساءل عن عدد الناطقين بالفرنسية الذين يتابعون ما يُكتب بالعربية ويتتبعون كُتابا بعينهم في مجال الثقافة العربية، وهو أمر لا يُطرح كثيرا بالنسبة لعدد من قراء العربية يحاولون، بانتظام يكاد يكون رتيبا، الاطلاع على ما يُكتب بالفرنسية، استزادة للمعرفة، أو فضولا يبحث عن جديد، أو تقربا من أهل "السبية" الجائرة.
لكنني لا أدري لماذا يريد البعض عندنا أن يكون كاتب ياسين، وله قدره واحترامه في مجال تخصصه، مرادفا وحيدا لاسم الجزائر، في حين يجري تجاهل رموز وطنية لمجرد أنها تكتب بالعربية، ويراها الوطن العربي تجسيدا للجزائر وتعبيرا عنها، بينما يجهلها ويتجاهلها بضعة آلاف تعطى لهم الصدارة لأنهم اخترعوا أسطورة "غنيمة الحرب" ثم صدقوها ويريدون منا أن نسلم لهم بالريادة، ونهمل رموزا من أمثال عبد الله شريط ومزيان وخرفي ووطار وركيبي وزهور وولد خليفة وسعيدي، وقبلهم ابن باديس والميلي ثم عبد الرحمن الجيلالي، ومعهم دودو وبو عزيز والعربي الزبيري، ثم بو عقبة والعقاب ورزاقي وبو القرون ورحايلية أو البرناوي وخمار وعشرات آخرون، ملاحظا أنني تناسيت نفسي.
بل يريدنا البعض أن نتجاهل كتابا وطنيين عبروا بالفرنسية مثل مالك بنابي ومالك حداد ولكن التزامهم بحضارتهم جعلهم رموزا تاريخية.
ولا أعرف كيف لا يتوقف أحد عند مأساة المسرح الوطني الذي أدت انعكاسات الشرخ اللغوي إلى تدمير دوره، فلم يعد هناك مسرح وطني يكون تجسيدا لمشاعر أمة وتعبيرا عن إرادتها السياسية وانسجاما مع ذوقها الفني وترجمة لوجهتها الاجتماعية.
ولن أتوقف عند الأغاني فقد تكفلت الأعراس بتلويث الواجهة الغنائية للبلاد، ولم تنتج الجزائر منذ الاستقلال، ودائما نتيجة للشرخ اللغوي، مطربا يُمكن أن يُجسد الوطن كله، وهكذا ظللنا عالة على ميراث قبل الثورة، وفيه ما يُمكن أن يُقال، وتصدرت الساحة صورا من الغناء المُبتذل الذي تمكنت الآلات النحاسية من جعله أداة صاخبة لإلهاء الجمهور بالرقص المتشنج.
أما الفنون التشكيلية فقد تحولت غالبا إلى مجرد مصدر رزق يعتمد التقليد تلبية لرغبة أثرياء جدد يريدون "تزويق" منازلهم بما يتصورون أنه لوحات فنية أو لتوفير سلعة فولكلورية رخيصة يأخذها السواح معهم وهم يعودون إلى بلادهم.
ذلك كله أمر يثير التساؤل حول المنطلقات ويستثير الشكوك حول الخلفيات، وبحيث أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم على خلفية قضايا الثقافة والفكر واللغة الوطنية وعند الحديث عن النخبة وموقعها ودورها : من يمثلُ من، ومن يُعبّرُ عن من، ومن نشلت منه بطاقة تعريفه فأصبح شبحا بغير وجود، ومن ينتحل دورا مزيفا وينتزع مكانة غير مشروعة ببطاقة مزورة؟
ومن الذي يتآمر على تزوير الإرادة التاريخية للأمة وعلى تشويه دورها الحضاري؟
الصورة الثقافية إذن قاتمة، ولعلها أكثر ظلاما مما قدمته باقتضاب، والوضعية اللغوية كارثة وطنية، وهذا كله يهدد بتحول الشعب إلى مجرد سكان (Population).
وأنا أعرف أن كثيرين كانوا ينتظرون مني أن أكتفي بأن أصب جام غضبي على تقصير الحكام وتقاعس القيادات السياسية، لكنني أكرر بأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع، وهو ما يجعلني أسجل تقديري للقلة التي ثبتت على المبدأ، أفرادا أو مؤسسات ، والتي تحاول أن تحافظ على ضوء شمعة يخترق الظلام ويحافظ على الأمل، ولهم أقول : فليكثر الله من أمثالكم.
|
|
|
|
|
|