|
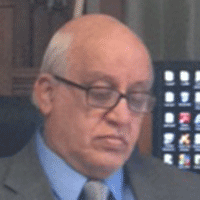
مسائلٌ نحويَّة لضرائرٍ شعريَّة - 2
أ. كريم مرزة الأسدي
ليست بمعلومات فقط ، كما يتوهّم بعض القرّاء الكرام ، وإنّما تبين مدى دقّة لغتنا الجميلة وعبقريتها ، وتوسّع إدراك عقولنا ، وتزيد نباهة أذهاننا ، والعلوم متداخلة المسارب ، متكاملة في رقيّها وتطورها:
الْمُقَدَّمَةُ : مَا بَيْنَ زَيْغِ الإعْرَابِ وقُبْحِ الزّحَافِ والضَّرَائِرِ الشِّعْرِيّةِ :
يقول ابن جني (ت 392 هـ ) في (خصائصه) :" اعلم أن البيت إذا تجاذبه أمران : زَيْغ الإعراب وقُبْح الزحاف فإنّ الجفاةَ الفصحاءَ لا يَحْفلون بقُبح الزّحاف إذا أدى إلى صحّة الإعراب ... فإن أمنتَ كَسْر البيت اجتنبتَ ضَعْفَ الإعراب وإن أشفقتَ من كسره ألبتَّة دخلتَ تحت كسر الإعراب . " (1)
من هنا نستطيع أن نتفهم بموضوعية تامة أنّ الموازنة صعبة بين الزيغ والقبح ، تحتاج إلى مهارة لغوية ونحوية وعروضية وفكرية وجمالية عالية ، فالحكم على الشعر والشاعر ليس بهينٍ ، وإن تهاون من لا يعرف أسرار وخفايا الإبداع ، بل الإلهام الفني الشعري ، وعليك أن تميّز بين من يتذوق الشعر العربي ، وهم غالبية العرب ، ومعظم ناسهم ، وبين من يحكم على صحته لغوياً وعروضياً وفنياً ، وأكرر ما قلت ذات يوم :
الشعر ليس بمفرداته ومضمونه ومعناه وصوره فقط ، بل بموسيقاه وانسيابه وأشجانه وألحانه ، تقرأه بنغماته الشجيه الصادرة من أعماق قلوبٍ متأججة شاعرة لتطرب إليه ، وتتغنى به ، فهو ليس مجموعة لحبات ٍمن العنب متكتلة متراكمة بترتيبٍ معين ، وتنظيم دقيق لتمنحك صوراً جميلة ، وتشكيلاتٍ بديعة لمعان ٍعميقة على أحسن الأحوال ... وإنما هو تحول نوعي تام من حالٍ الى حال ، ليصبح في صيرورة جديدة ... كأس مُدامةٍ وكرعة راح ٍ " وإنَ في الخمر معنى ليس في العنب " . ِ يقول أبو العباس الناشىء الأكبر عن شعره :
يتحيرُ الشعراءُ إنْ سمعوا بهِ ***في حُسن ِ صنعتهِ وفي تأليفــهِ
شجرٌ بدا للعين ِحُســـنُ نباتهِ ***ونأى عن الأيدي جنى مقطوفهِ
وللشعر ركنان أساسيان لابدَّ منهما في كلّ شعر ٍ ، وهما النظم الجيد ونعني به الشكل والوزن أولاً (ويخضع كما هو معلوم لعلوم النحو والصرف والبلاغة والعروض ) ، ثم المحتوى الجميل أو المضمون الذي ينفذ إلى أعماق وجدانك ، وتنتشي به نفسك دون أن تعرف سره ، وتفقه كنهه ، فهو الشعاع الغامض المنبعث من النفس الشاعرة .
أمّا الضَّرَائِرُ الشِّعْرِيّةُ فهي مخالفات لغوية ، قد يلجأ إليها الشاعر مراعاة للقواعد العروضية وأحكامها،لاستقامة الوزن ولا تُعدّ عيباً ، ولا خطأً ، إذا كانت وفق ما تعارف عليه عباقرة العرب من الشعراء والنقاد والعروضيين القدماء ، وقبلوا به ، سواء كان للشاعر فيه مندوحة أم لا ،والحقيقة أول من شرع بأحكام الضرورة سيبويه (188 هـ ) في كتابه (لكتاب) دون تعريف أو تنظيم ، ووضعها في باب (ما يحتمل الشعر ) ، واستند على أستاذه الخليل في بعض أحكامه ، ولما جاء ابن فارس ( 395 هـ) أجاز الضرورات الشعرية على أن لا تخل بالإعراب ، وأول من ألف كتاب (ضرورة الشعر) أبو سعيد السيرافي (ت 369 هـ) ، وتطرق إلى تسعة أوجه منها ،ولكن أهم كتاب في هذا المجال هو(ضرائر الشعر ) لابن عصفور (ت 669 )، حيث جمع فيه جهود كل من سبقه ، مهما يكن تصنف على ثلاثة أسس ، وهي: ضرورة الزيادة ، وضرورة الحذف ، وضرورة التغيير ، وكلّ ما يصحّ أن يأتي بالنثر ، لا يعدّ من الضرورات في الشعر ، لأن الناثر لا يجوز أن يلجأ للضرورة ، لعدم إلزامه بالإيقاع الوزني .
ونحن الآن أحوج للضرائر الشعرية ، وربما أحياناً في النصوص النثرية ، وخصوصاً قصيدة النثر ، ولكن شرط عدم اللحن ، وتوليد ألفاظ عديدة لمعنى واحد ، وبالتالي تتشتت اللغة ، ويصبح لكل مجموعة ، أو قبيلة ، أو قطر لغتهم الخاصة بهم ، ومن المعروف والثابت أن العرب - إلى يومنا هذا - أمة تؤمن بالأصالة نسباً و حسباً ، تتشبث بالقبيلة والعشيرة ، والمنطقة ، وتتعدى ذلك للحسب وجاهة وأعياناً وثراءً ، وغير ذلك من صغائر الأمور، فمن باب أولى وأجدى وأبقى وأخلد التعلق بأصالة اللغة التي توحّدنا ، وتشدّ أزرنا ، وتقرّبنا من بعضنا، بعد الويلات والنكبات والنعرات !! ، وإذا عجز قياس البصريين ، فعلينا بالأصيل العريق من الشاذ من مدرسة الكوفيين ، وفي لغتنا الجميلة الخالدة سعة في الأقوال والمعاني والفكر والعقل والخيال ...!! وإليك ما يقول أبو الفتح عثمان ابن جني ( 322 - 392 هـ / 933 - 1000م ) في (خصائصه ) ، وكثيراً ما يلجأ إلى أقوال أستاذه أبي علي الفارسي ( 900-987م / 288-377 هـ ) ، : اقرأ ابن جني بخصائصه : " فإذا جاز هذا للعرب عن غير حصر ولا ضرورة قول ، كان استعمال الضرورة في الشعر للمولدين أسهل وهم فيه أعذر ، فأما ما يأتى عن العرب لحنا فلا نعذر في مثله مولدا... وقد نص أبو عثمان عليه فقال ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب.
وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك اولى بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحد من هنا ومن هنا ورويت عن الأصمعي قال اختلف رجلان في الصقر فقال أحدهما الصقر بالصاد وقال الآخر السقر بالسين فتراضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما هما فيه فقال لا أقول كما قلتا إنما هو الزقر أفلا ترى إلى كل واحد من الثلاثة كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين أخريين معها وهكذا تتداخل اللغات " (2)
تكفينا هذه المقدمة، وإليكم تكملة ما تيسّر لنا من المسائل اللغوية والضرائر الشعرية ، إضافة لما أوردناه في الحلقة الأولى :
6 - الفرزدق يُدخل (الـ ) على الفعل المضارع في بيته :
ما أنتَ بالحكمِ التُرضى حكومته *** ولا الأصيلِ ولا ذي الرأي والجدلِ
هذا الفرزدق الزاهي بموهبته، والمتماهي بأصالته ، وأروم عراقته ، لا يبالي باللغويين والنحويين ، ويقول : علي ّأن أقول ، وعليكم أنْ تحتجوا بشعري ، فذهب هؤلاء العلماء من بعده
منقسمين بين من يرى الأمر ضرورة في لحظة النظم ، وبين من يحكم بالاختيار ، لأنهم يقولون ببساطة ، كان يمكنه ، أن يبدل بـ (التُرضى) (المرضي) ، وينتهي الإشكال !!
ولكن يذكر كاتب هذه السطور في كتابه (نشأة النحو ...) أنّ الكوفيين كانوا يعدون الألف واللام من الأسماء الموصولة بمعنى الذي ، التي ، الذين ، اللواتي ... ، لذلك كان يقول الفرزدق علي أن أقول ، وعليكم أن تحتجوا ، ولا أعرف كيف فات الأمر على بعض علفماء اللغة ، وقالوا كان بإمكانه أن يقول : ( المرضي) ، والحقيقة كان يريد أنْ يقول (الذي تُرضى حكومته ) !! ، وخذْ شاهداً أخر :
من القوم (الرسول) الله منهم *** لهم دانتْ رقاب بني معدِّ
أي بمعنى (من القوم الذين رسول الله منهم) ، وتمتع بمثال ثالث :
مَنْ لا يزال شاكراً على (المعه) *** فهو حر بعيشةٍ ذات سعه (18)
بمعنى ( على الذي معه) ، وقد أجاز ابن مالك في (ألفيته) هذه (الـ) الموصولة ، بقوله :
وصفةٌ صريحةٌ صلة الْ *** وكونها بمعرب الأفعال قلْ (19)
هل اقتنعت أنّ الألف واللام كانت تعني الأسماء الموصولة ، أم لا ؟ فلماذا ذهب هؤلاء يشرقون ويغربون ولا يشيرون ولا يبحثون ؟!!
7 - وقد فصل هذا الفرزدق بين (ما ) و(زال) في الفعل الماضي الناقص (ما زال) بـ (إنْ) - والرجل يحتج بشعره - وذلك في قوله :
رأيتُ تَباشيرَ العُقوقِ هي الَّتي *** مِنِ ابنِ امرِئٍ ما إن يَزالُ يُعاتِبُه
وأبو تمام لم يسمع هذا من العرب ، ولكن لمّا وجد العرب يأتون بـ ( إنْ) بعد (ما) النافية ، قاس الأمر على (مازال ) ، وأدخلها في عدة مواقع من شعره ، وإليك هذا البيت :
وَما إن زالَ في جَرمِ بنِ عَمرٍو *** كَريمٌ مِن بَني عَبدِ الكَريمِ
وسار على هذا النهج شعراء عصره كأبي نؤاس والبحتري وابن الرومي ، بل أورد ابن هشام أحد شواهده ، يتضمن مثل هذه الـ (إنْ) المحشورة (20) .
8 - وقد ذكرت في كتابي (نشأة النحو ..)، قد أجاز الكوفيون إظهار (أن) بعد (كي) كقول الشاعر :
أردتُ لكيما أنْ تطير بقربتي *** فتتركها شنّاً ببيداءِ بلقعِ
وأجازوا أيضاً دخول اللام في خبر (لكن) ، كقول الشاعر : ( ولكنني من حبّها لعميدُ) ، والمتنبي يحذف (أنْ) الناصبة للفعل المضارع ، ويفعلها في بيته :
وقبل يرى من جوده ما رأيتهُ *** ويسمعَ فيهِ ما سمعت من العذلِ (21)
وأراد ( أنْ يرى) .
9 - وقد يؤنث الشاعر الفعل مع المذكر كقول جرير يهجو ابن جرموز:
لما أتى خبر الزبير تواضعت*** سور المدينة والجبال الخشَّع
فأتى الشاعر بـ (سور) ، بعد فعل ألحقتْ به تاء التأنيث الساكنة ، ويعلل ابن منظور في (لسانه) ، لأن السور جزء من المدينة ، فكأنه قال : تواضعت المدينة !! (22)
وقد يحدث العكس تذكير ما يوجب تأنيثه ، ففي البيت الآتي (رؤية معين) ، والحق ( رؤية معينة) :
رؤية الفكر ما يؤل له الأمر *** معينٌ على اجتناب التواني
و يعلل السيوطي في (همع هوامعه) : قد يكتسب المضاف من المضاف إليه تأنيثا وتذكيرا إن صح حذفه ولم يختل الكلام به وكان بعضا من المضاف إليه أو كبعض منه كقولهم قطعت بعض أصابعه ، وقول الشاعر : ( كما شرقت صدر القناة من الدم ) (23)
10- لا يجيز النحويون أنْ تأتي (أن) بين (كاد) و(يفعل) ، وإنما تقول العرب (كاد يفعل)، هذا في الكلام ، ولكن في الشعر تأتي ضرورة ، قال ابن الأعرابي-الرجز :
يكاد لولا سيره أن يملصا *** جدبه الكصيص ثم كصكصا (24)
لولا الضرورة الشعرية ، لقال المتكلم ( يكاد لولا سيره يملصا ) .
11 - ويورد كاتب هذه السطور في (نشأته ...) ، أجاز المازني وهو شيخ البصريين دخول الباء على الفاعل ، وهذا شاذ ، بمعنى أنه ساير الكوفيين ، في البيت الآتي :
إذا لاقيتِ قوماً فاسأليهم *** كفى قوماً بصاحبهم خبيرا
وهذا من المقلوب ، ومعناه ( كفى بقوم خبيراً صاحبهم ، فجعل الباء في ( الصاحب ) ، وموضعها (القوم) ، ، وفي القران الكريم شاهد ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ، ، والتقدير - والله الأعلم - (ولا تلقوا أيديكم) . (25)
12 - أجاز المبرد شيخ البصريين - قياساً - دخول (حتى) العاطفة على الضمائر :
وأكفيه ما يخشى وأعطيه سؤلهُ *** وألحقه بالقوم حتّاه لاحقُ
ويعقب عبد القادر البغدادي في (خزانته) "على أن المبرد زعم أن حتى هنا جرت الضمير. وليس كذلك، وإنما حتى هنا ابتدائية، والضمير أصله هو، فحذف الواو ضرورة " (26)
وقول الآخر (الوافر) :
فلا والله لا يلقي أناسٌ *** فتىً حتّاك يا بن أبي يزيد
ويعقب البغدادي نفسه " على أن المبرد تمسك به على أن حتى تجر الضمير ، وأجاب الشارح المحقق بأنه شاذ. والأحسن أن يقول ضرورة، فإنه لم يرد في كلام منثور " (27)
13 - منع صرف المصروف : يذكر كاتب هذه السطور في (نشأته) : البصريون لا يجيزون منع صرف المصروف حتى ضرورة في الشعر ، ولكن الكوفيين يجيزون ذلك ، والمتنبي سار على نحوهم ،فهو منهم ، خذ هذا البيت منه :
وحمدانُ حمدونٌ ، و(حمدونُ) حارثٌ *** و(حارثُ ) لقمانٌ ، ولقمانُ راشدِ
قال أبو البقاء العكبري في (تبيانه) : " ترك صرف حمدون وحارث ضرورة ، وهو جائز عندنا ( يقصد الكوفيين) ،غير جائز عند البصريين " (28) ، وحصرتُ لك الكلمتين بين قوسين في البيت ، لكي تستدل عليهما - للقارئ العام - ، وفي عصرنا أيضاً ، ذهب الجواهري الكوفي على مذهب المتنبي ، إذ خاطبه ، ومنع ابنه ( محسّد ) من الصرف ، وهو مصروف ، قائلاً :
ومنْ قبلِ ألفٍ عوى ألفٌ فما انتفضتْ *** أبا (محسّدَ) بالشّتم الأعاريبُ
العجز حقّه ( أبا محسّدٍ) ، ولكن لا يستقيم الوزن ، فلجأ للضرورة التي يوافق عليها الكوفيون ، ويتحفظ عليها البصريون ، والنحو الحالي نحوهم . (29)
ويقول معروف الرصافي :
(أسماءُ) ليسَ لنا سوى الفاظِها *** أمّا معانيها فليستْ تُعرفُ
(أسماء) كلمة مصروفة، وإن كانت على وزن (فعلاء) ، لأنّ أصل همزتها واو(أسماو) ، وقلبت ، هذا حسب رأي البصريين ، فعندهم الاسم مشتق من السمو ، بينما يذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من (الوسم) (30) ، قال تعالى : ( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ...) ( النجم - 23 ) .
وعلى العموم ،الكلمات المنتهية بألف ممدودة ( اء ) على أربعة أقسام :
أ - أسماء مبنية مثل (هؤلاءِ ) ، فهي مبنية على الكسر ، غير مشمولة بأحكام الأسماء المصروفة وغير المصروفة ، لأن هذه الأحكام تخص الأسماء المعربة .
ب - أن تكون الهمزة فيها أصلية مثل (قرّاء ) من قرأ ، و(إنشاء) من نشأ ، و (وضاء) ، هذه مصروفة ، الأولى على وزن ( فعّال) ، والثانية على وزن (إفعال) ، والثالثة على وزن (فعال) .
ج - أنْ تكون الهمزة فيها منقلبة مثل ( أسماء) جمع (اسم) منقلبة من الواو (السمو)،فهي مصروفة أيضاً كسابقتها ، شرط أن لا تكون الكلمة اسم علم كـ (أسماء) ، فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث.
نعود ، وكلمة ( قضاء ) منقلبة من ياء وأصلها يقضي ، و (استدعاء ) همزتها منقلبة من واو ، وأصلها يدعو ، خلاصة الكلام ( أسماء واستدعاء وقضاء ) أسما مصروفة ، لأن همزتها منقلبة .
د - أمّا القسم الرابع من الكلمات ، فتكون الهمزة فيها زائدة كـ ( علماء ، صحراء ،حسناء ، شعراء ، فقراء ، أقرباء ،أصدقاء ، وأشياء) ، وفي هذه الحالة يمنع الاسم من الصرف ، فكما ترى (علماء) من علم ، فالهمزة زائدة ، وكذلك (صحراء) من صحر ، و(حسناء) من حسن ... وأخيراً (أشياء) من شيء على وزن (فعل) ، فعند الجمع تدحرجت الهمزة إلى بداية الكلمة (قلب مكاني) ، فأصبحت (أشي على وزن لفع ) ، وزيدت ألف التأنيث الممدودة (اء) ، فصارت (أشياء) على وزن لفعاء ، فهمزتها زائدة ، تمنع من الصرف - وقال الكسائي على وزن أفعال - والقرآن الكريم خير شاهد (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) (المائدة 101 )
14 - صرف الممنوع من الصرف : اتفق البصريون والكوفيون على جواز صرف الممنوع من الصرف ضرورة في الشعر:
قال امرؤ القيس ، وهو من أوائل شعراء العربية ممن وصلنا شعرهم :
ولمّا دخلت الخدر خدر عنيزة ٍ *** فقالت لك الويلات إنّك فاضحي
وقد صرف (عنيزةٍ) ، وهي ممنوعة من الصرف لعلميتها وتأنيثها ، وتائها المربوطة ، وقول الأخطل ، وقد صرف ( مثاكيلٍ) ، في بيته التالي من البسيط ، والكلمة ممنوعة من الصرف على وزن (مفاعيل) :
كَلَمعِ أَيدي مَثاكيلٍ مُسَلِّبَةٍ *** يَنعَينَ فِتيانَ ضَرسِ الدَهرِ وَالخُطُبِ
كان بإمكان الأخطل لا يصرف ( مثاكيلٍ) ، ويدعها (مثاكيلَ ) ، ويمشي صدر البيت ، إذ تمر التفعيلة الثالثة من الصدر (مستفعلن) بزحاف الطي ، فتصبح التفعيلة (مسْتعلن) ، وهي من جوازات البسيط ، ولكن الرجل أراد استقرارها للطف الوزن ، وهو محق ، وخذ قول الشاعر ، وقد صرف (أنطاكيةٍ) ، وهي علم أعجمي مؤنث :
علونَ بأنطاكيّة ٍ فوق عجمة ٍ * كجرمة ِ نخل ٍ أو كجنّة يثربِ
ويروي ابن أبي الأصبع في (تحريره) قول " أبي حية النميري فيما قاله في زينب أخت الحجاج حيث قال طويل
تضوّع مسكاً بطن نعمان إذ مشتْ *** به زينبٌ في نسوة عطراتِ " (31)
15 - تنوين المنادى المبني كتنوين كلمة (جملٌ)،وهي مبنية على الضم :
ليت التحية لي فأشكرها ***مكان يا (جملٌ) حييت يا رجلُ
يروي ابن منظور في (مختصره لتاريخ دمشق) كانت عزة لسبب قد حلفت أن لا تكلم كثيراً سنةٌ، فلما انصرفت من الحج بصرت بكثير وهو على جمله يخفق نعاساً، فضربت رجله بيدها وقالت: كيف أنت ياجمل؟ فأنشأ كثير يقول - من البسيط - :
حيتك عزة بعد الحج وانصرفت *** فحيّ ويحك من حياك يا جملُ
لو كنت حييتها لا زلت ذا مقةٍ *** عندي ولا مسك الإدلاج والعملُ
ليت التحية كانت لي فأشكرها *** مكان يا (جملٌ ) حييت يا رجلُ (32)
وأكثر من هذا ما يستشهد به ابن عقيل في ( شرحه لألفية ابن مالك ) ، الشاهد (308) :
ضربت صدرها الي وقالت*** يا ( عديا ً) لقد وقتك الاواقي
هذا البيت للمهلهل بن ربيعة أخي كليب ، من أبيات يتغزل فيها بابنة المحلل ، والشاهد بالبيت (يا عَدِيّاً) حيث اضطر الشاعر إلى تنوين المنادى ، ولم يكتفِ بذلك ، بل نصبه مع كونه مفرداً علماً ، ليشابه به المنادى المعرب المنون بأصله ، وهو النكرة غير المقصودة (33) كل الضرورات يوظفها الشاعر لكي لا يتجاوز أوزان بحور الخليل ، وما تداركه الأخفش الأوسط ، بتمامها ومجزوءاتها ، ومشطوراتها ، ومنهوكاتها ، وبكل أنواع أضربها ، لا لكي نوّلد أوزان أخرى غير مضمونة النتائج ، و يمجّها الذوق العربي ، وتقذف به الأذن العربية إلى سلة المهملات ، التجديد بحاجة إلى عباقرة يفرضون ذوقهم الفني واللغوي والإيقاعي على مسامع الأمة ، وسلامة اللغة من الضياع أو الأنحراف ، وتتوارث تجربتهم الأجيال بالتصفيق والارتياح ، وما جيل روّاد شعر التفعيلة إلا شهداء على ما نقول ، والإبداع الإنساني ولود لا يزول ، وإلى حلقة قادمة عن الضرورات والشعر الرائع المأمول !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (الخصائص ) : أبو الفتح عثمان بن جني - تح محمد علي النجار - ج 1 - ص 333 - عالم الكتب - بيروت .
(2) 1 / 329 - 374 ) م . ن .
(18) ص 122 م . س . (نشأة النحو العربي ...) : كريم مرزة الاسدي - - دار الحصاد - 2003 م - دمشق
(19) ( شرح ابن عقيل ) : ج 1 - ص 155
(20 ) - مسائل نحوية من كتاب ( شعر أبي تمام دراسة نحوية)
http://majles.alukah.net
(21) راجع (نشأة النحو ...) : ص 35 ، 70 على التوالي . م. س .
(22) (لسان العرب) : ابن منظور - ج 4 - الصفحة 365 - موقع مكتبة الشيعة .
(23) (همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع) : للإمام السيوطى - ج2 - ص 352 - الموسوعة الشاملة .
(24) ( الأغاني ) :ابن منظور - ج 4 - ص 141- دار صادر - 2003 م .
(25) ( نشأة النحو العربي ...) : ص 44 - م. س .
(26) (خزانة الأدب) : عبد القادر البغدادي - ج 3 - ص 413 - الوراق - الموسوعة الشاملة (27) م . ن .
(28) ( التبيان في شرح الديوان) : أبو البقاء العكبري - 1 / 173 - طبعة الحلبي .
(29) ( نشأة النحو العربي ..) : كريم مرزة الاسدي - ص 71 - م. س .
(30) ص 87 م . س .
(31) (تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر) : ابن أبي الأصبع - 1 / 103 - الوراق - الموسوعة الشاملة .
(32) ( مختصر تاريخ دمشق ) : ابن منظور - 6 / 241 - الوراق - الموسوعة الشاملة .
(33) (شرح ابن عقيل ) : ابن عقيل العقيلي - ج 2 ص 263 - الشاهد 308 - راجع .
|